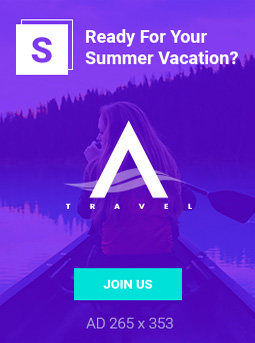عجز ميزان المدفوعات: النار تحت الرماد مجدداً -- Oct 09 , 2025 127
ماهر سلامة - الاخبار
تعيش أركان السلطة في لبنان على التناقضات التي يغرق فيها مجلس الوزراء بعيداً من أي نقاش متصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية. ففيما يصرّح وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط بأن «هناك مؤشّرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي، ونتطلّع إلى سنة واعدة للاقتصاد اللبناني»، وذلك بهدف الترويج لمؤتمر «بيروت 1» الذي ينوي عقده في 18 و19 تشرين الأول المقبل، يصرّح وزير المال ياسين جابر بأن ميزان المدفوعات يسجّل عجزاً.
والرأيين لا يستندان إلى أي أرقام، إلا أنه ثمة الكثير من الوقائع التي تؤيّد كلام جابر، ومنها أن الاستيراد بلغ في أول سبعة أشهر من السنة 11.1 مليار دولار، وأن التوقعات تشير إلى أنه سيبلغ 20 مليار دولار في نهاية السنة الجارية، وهو رقم قياسي مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة حين بلغ ذروته في 2017 مسجّلاً 19.6 مليار دولار. بهذا المعنى، فإن المؤشرات التي يتحدث عنها بساط ليست إلا وهماً مالياً يتعلق بالاستهلاك الذي يمكن تفسيره بهذا المقدار القياسي من الاستيراد.
في الواقع، يعيدنا كلام جابر عن عجز في ميزان المدفوعات إلى فترة ما قبل الأزمة. فهذا العجز الذي ظهر اعتباراً من 2011 كان أحد أبرز المؤشرات على قرب الانهيار، وعودة هذا العارض اليوم تعني أن المشكلة ستتكرّر عاجلاً أم آجلاً مع الكثير من التشوّهات الإضافية التي خلقت بفعل الانهيار. وهذا يعرّي الحديث المتكرّر عن مسار التعافي، من قبل الحكومات المتعاقبة، ولا سيّما الحكومة الحالية التي تُقدّم نفسها على أنها إصلاحية.
ميزان المدفوعات هو سجل محاسبي يوضح كل التدفقات المالية والاقتصادية بين دولة ما، والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محدّدة. ويعكس أيضاً وضعها التجاري والمالي وقدرتها على تغطية التزاماتها الخارجية. وعندما يُصبح ميزان المدفوعات في حالة عجز فهذا يعني أن البلد ينزف العملات الأجنبية.
وأبرز دليل على وجود النزف رغم غياب الإحصاءات، هو العجز المتواصل في الميزان الجاري الذي يعدّ جزءاً أساسياً من ميزان المدفوعات.
فالميزان الجاري يسجّل عجزاً كبيراً منذ ما قبل الانهيار. في عام 2024 بلغ عجز الميزان الجاري 5.56 مليارات دولار، وفي السنة التي سبقت بلغ 5.88 مليارات دولار، وقبلها كان 7.42 مليارات دولار... رغم ذلك، فإن الأرقام التي ينشرها مصرف لبنان عن «صافي التغيّر في الموجودات الأجنبية»، والتي تظهر فائضاً في هذه الموجودات، يخفي حقيقة أساسية، وهي أن هذا الصافي ليس ميزاناً للمدفوعات، بل يتضمن تقديرات عن الاقتصاد الموازي تجعل هذا الصافي ينتفخ ليصبح فائضاً بدلاً من أن يكون سلبياً.
والاقتصاد الموازي هو النشاطات التي تتم خارج الاقتصاد الرسمي أو المصرّح عنه، وبالتالي يتضمن الاقتصاد الموازي مدخرات المنازل والتحويلات الآتية نقداً إلى الأسر اللبنانية من المغتربين، ويتضمن أيضاً الإنفاق السياسي الذي لا يظهر في القنوات الرسمية.
والمدخرات والإنفاق السياسي هما ما يجعل الاقتصاد يبدو «أحسن» كما يراه الوزير عامر بساط، لأن الأموال المدخرة والصرف السياسي يحسّنان الاستهلاك ويؤديان إلى انتفاخ في الناتج المحلي الإجمالي ليس له أي مصدر يتعلق بأي قيمة إنتاجية في الاقتصاد.
في السابق، كان «صافي التغيّر في الموجودات الأجنبية» يعبّر أكثر عن ميزان المدفوعات بسبب هيمنة الحصة الصغيرة للاقتصاد الموازي من حجم الاقتصاد الوطني كلّه. وكانت احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية هي الأساس في تمويل أي عجز. أما اليوم، فقد اختلف الوضع، لأن النزف لم يعد يموّل من احتياطات مصرف لبنان، بل إن هذه الأخيرة تتزايد بشكل غير مفهوم، فضلاً عن أن القطاع المصرفي معطل من 2019، وبالتالي لا يبقى أي ممول فعلي للعجز الظاهر في الحساب الجاري سوى الأموال المخزنة في المنازل التي تُستنزف على الاستهلاك بشكل أساسي.
لكن هناك سؤال اليوم: لماذا يواصل المقيمون في لبنان الاستهلاك رغم أن قدرتهم الشرائية انخفضت بعد انهيار قيمة الليرة؟ في الواقع، كانت القدرة الشرائية في السابق مضخّمة أكثر مما هي عليه اليوم بأضعاف بسبب تثبيت سعر الصرف. عملياً، كان سعر الليرة مدعوماً بالسياسات النقدية.
أما اليوم، فمع العودة إلى تثبيت سعر الصرف ودولرة الاقتصاد بشكل نقدي، بالإضافة إلى استقرار في تدفقات المغتربين إلى لبنان، سواء نقداً أو عبر التحويلات الرسمية، وانكفاء السلطة عن أي دور يتعلق بتغيير جذري في بنية الاقتصاد في لبنان، عاد الاستهلاك المموّل خارجياً ليصبح العامل الأساسي في الاقتصاد، وفي تأثيره على الأسعار.
فالأسعار، منذ دولرتها، تسجّل ارتفاعاً متواصلاً وكبيراً، ومعدلات التضخّم عالية جداً، والاقتصاد يعمل من جانب القطاع الخاص بشكل أساسي بعدما جرى تغييب الدولة عن حصّتها الأساسية منه في ظل موازنات تشغيلية فيها أجور لا تغطي شراء غذاء يكفي للبقاء على قيد الحياة، واختارت السلطة انهيار المؤسسات والإدارات العامة وحرمانها من شروط الاستمرار ولو بالحدّ الأدنى.
ما قد يلعب دوراً في تخفيف عبء النزف في الاقتصاد هو تطبيق قانون كابيتال كونترول جدّي، يجعل التحويلات بالعملات الأجنبية إلى الخارج بهدف الاستيراد محدّد الشروط. ومن المثير للاهتمام أن صندوق النقد، الذي يُعرف بأن الكابيتال كونترول يخالف عقيدته بالتدخل في النشاط الاقتصادي، إلا أنه أوصى بتطبيق قانون كابيتال كنترول، ولكنه يعتقد أن ضبط النزف أهم للعودة إلى نوع من الاستقرار المالي.
ولا يمكن اعتبار الكابيتال كونترول حلّاً نهائياً، لأنه لا يعالج أصل المشكلة، بل يحدّ من عوارض النزف المالي. فأصل المشكلة في الاقتصاد اللبناني بنيوي، إذ إن الإنتاج في الاقتصاد شبه معدوم، وهذا أمر له أسبابه التي يجب أن تُعالج. فالإنتاج بحاجة إلى بنى تحتية تؤمنها الدولة، تسهم في تسهيله وفي خفض كلفته وبالتالي جعله أكثر تنافسية وأكثر ربحية، وهو ما يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمار في الإنتاج. الأكيد أن تحقيق هذا الأمر ليس بهذه البساطة، ولكنه الطريق الحقيقي لمعالجة المشكلة البنيوية في الاقتصاد.
في مقابل هذا كله، تمارس الحكومات المتعاقبة، وهذه الحكومة من ضمنها، سياسة مالية غير فاعلة. تتفرّج على انكماش الموازنة من نحو 17.5 مليار دولار في 2018 إلى 5.7 مليارات دولار في موازنة 2026.
وهذا لا ينعكس فقط على ترهّل الخدمات التي تقدّمها الدولة، بل أيضاً على تأثير السياسة المالية على الاقتصاد. وكما هو واضح من سياسات الحكومة المالية، التي تهدف فقط إلى تصفير العجز في الموازنة، ليس هناك أي نية للتغيير في وجهة السياسة المالية، بجعلها أكثر فعالية تجاه الاقتصاد.
غياب هذه السياسة يحول دون قدرة السلطات المالية على التدخّل في الاقتصاد. حتى لو لم تكن الحكومة تريد أن تفرض كابيتال كونترول صريحاً، كان يمكنها أن تفعل ذلك عبر تطبيق القيود على الاستيراد (import control) عبر زيادة الرسوم الجمركية على بضائع معينة.
أرقام وهمية
الأرقام التي ينشرها مصرف لبنان عن ميزان المدفوعات ليست أرقاماً دقيقة، لذلك استُخدم حساب التغيّر في صافي الموجودات الخارجية للقطاع المصرفي كمؤشّر يحاكي ميزان المدفوعات. هذا الحساب كان يظهر في السنتين الأخيرتين فائضاً كبيراً، حيث بلغ في 2024 نحو 6.4 مليارات دولار وفي الأشهر السبعة الأولى من 2025 نحو 8.9 مليارات دولار. إلا أن هذه الأرقام لا تعبّر عن فائض في ميزان المدفوعات الحقيقي، بل هي بسبب ارتفاع سعر الذهب الذي يُعتبر من أصول مصرف لبنان الأجنبية، وارتفاع سعره ينعكس على التغيّر في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إيجاباً.