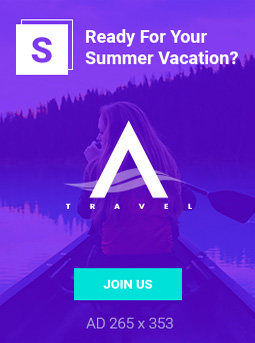هل هنالك علاقة غرامية بين الحكومة والمركزي والمصارف؟ -- Feb 06 , 2026 19
نزل المتقاعدون العسكريون إلى الشارع وقطعوا الطرقات، للمطالبة بجزء من حقوقهم، للحصول على أدنى مقوّمات العيش، وطالبوا بالحصول على 50% فقط من قيمة رواتبهم قبل الأزمة. مطلبٌ متواضع في جوهره، لا يعكس سوى حدٍّ أدنى من الحقوق، ويكشف في الوقت نفسه حجم التنازل القسري الذي فُرض عليهم، إذ إنّهم - على رغم من كل ما أصابهم - ما زالوا يتصرّفون بمسؤولية عالية.
لكن هذا الإجحاف لا يطال المتقاعدين العسكريِّين وحدهم، بل يمتدّ إلى العسكريِّين بالخدمة الفعلية، الذين تقلّصت رواتبهم وفُقدت تعويضاتهم، والكثير من موظفي القطاع العام الذين تآكلت مداخيلهم حتى فقدت قيمتها الفعلية (إلّا بعض المحظوظين)، وموظفي القطاع الخاص الذين ضاعت تعويضاتهم، بالإضافة إلى صناديق النقابات والمهن الحرّة التي احتُجزت أموالها في المصارف.
هؤلاء، في الحقيقة، لا تقلّ حقوقهم أبداً عن حقوق المودعين، لا قانونياً ولا أخلاقياً. والمستغرَب صمتهم المستمرّ، وغياب أي حراك ضاغط واسع ومنظّم، وعدم مطالبتهم بحقوقهم بكل الوسائل السلمية المشروعة، من احتجاجات واعتصامات وتحرّكات قانونية وإعلامية.
والردّ الرسمي على هذه المطالب دائم لا يتغيّر: «لا توجد أموال متوفّرة». وهل يُقصد بعدم وجود الأموال أنّها بحوزة المصارف، ونحن نردّد أنّ قسماً كبيراً من الأموال التي تسمّى غير موجودة، هي موجودة فعلاً في حسابات المصارف، والمركزي، وأصحابهم وشركائهم من المسؤولين، ولذلك، كثيرون يحاولون عرض حلول من دون تدقيق بما فعلته المصارف بمباركة المصرف المركزي ومسؤولين. وإذا كنّا على خطأ، فهناك وسيلة سهلة لإثبات ذلك، افتحوا حسابات المصارف والمركزي وباشروا التدقيق.
أمّا إعادة الحقوق لأصحابها، فلن تتمّ بالطريقة التي يرسمها المسؤولون حالياً، بل عبر تشخيص حقيقي للأزمة، يتضمّن محاسبة وتدقيقاً وفتح حسابات، وبعدها تُوضَع حلول واضحة.
الأسوأ أنّ هذه المصارف نفسها ما زالت تتمادى بالوقاحة. فعلى رغم من أنّها تسبّبت بتدمير حياة آلاف العائلات، فيما الأثر الاجتماعي لما حصل هو كارثة بكل ما للكلمة من معنى. ولا يوجد أي تبرير أخلاقي أو قانوني لما ارتكبته هذه المصارف بحق الناس. وتبقى الأسباب المحتملة لما جرى كلّها كارثية:
• إمّا أنّ ما حصل كان سرقة منظّمة ومدروسة، ارتُكبت عن سابق تصوّر وتصميم لإيصال البلاد إلى الإفلاس.
• أو أنّ طمع أصحاب المصارف بأرباح خيالية دفعهم للتخلّي عن واجبهم في حماية الودائع.
• أو أنّ الجهل وسوء الإدارة قاداهم إلى ارتكاب أخطاء قاتلة دمّرت بيوت الناس.
• أو هو خليط من الأسباب الثلاثة سوياً.
في كل الأحوال، هذه المصارف باتت غير مؤهّلة أخلاقياً أو مهنياً للبقاء في السوق المالي، ومَن يحاول تبييض صورتها يرتكب جرماً في حق البلد والناس.
ومِن العار أيضاً ما يُحاك اليوم في الكواليس: جهات سياسية ومالية تضغط بشكل منهجي لإعادة تعويم المنظومة نفسها، وتروّج لبقاء المصارف كما هي، وتفرض على الناس إعادة التعامل معها وكأنّ شيئاً لم يكن. كأنّ السرقة الجماعية لم تحصل، وكأنّ الودائع لم تُحتجز، وكأنّ الثقة لم تُدمَّر. بمعنى آخر «سرقوكم، لكن سنجبركم أن تتعاملوا معهم من جديد».
هذه ليست وقاحة سياسية فحسب، بل جريمة أخلاقية واقتصادية مكتملة الأركان. كيف يُطلب من الناس أن يثقوا مجدداً بمصارف يعتبرونها، عن حقّ، مؤسسات سارقة؟ بأي منطق ووقاحة؟ هل يُدار البلد بالأوهام؟ هل يُبنى الاقتصاد على النسيان القسري؟ أم أنّ المطلوب ببساطة هو تطبيع الجريمة وتحويلها إلى أمر واقع؟
هنا أود أن ألفت نظر الجميع، وخصوصاً البنك الدولي إلى ما حصل في أميركا، أي قضية برنارد مادوف في عملية اختلاس 65 مليار دولار، وعلى رغم من أنّ الدولة الأميركية لم تكن طرفاً في الجريمة، ولا متواطئة، ولا شريكة، ولا مستفيدة من هذا الاحتيال - بعكس ما حصل في لبنان حيث تداخلت الدولة والمصارف والمصرف المركزي في منظومة واحدة - تعاملت السلطات الأميركية مع القضية كجريمة كبرى لا كـ«خسارة سوق»، واعتبرت أنّ من مسؤوليّتها الحفاظ على مواطنيها الذين تعرّضوا للإحتيال. فأوقِف مادوف فوراً، صودِرت ممتلكاته، وعُيِّن وصيّ قضائي مستقل لتعقّب الأموال في الداخل والخارج، واسترجاعها من المستفيدين والشركات والصناديق التي تلقّت أموالاً غير شرعية.
وبفعل المسار القضائي الصارم وآليات الاسترداد القانونية، أُعيد للضحايا الجزء الأكبر من أموالهم، ووصلت نسب التعويض في العديد من الملفات إلى ما يقارب 90-95% من قيمة الخسائر، في سابقة أكّدت أنّ حماية المودعين ليست مسألة نوايا، بل قرار دولة وأولوية سيادية. ليتنا كنّا في أميركا!
أمّا في لبنان، فلا تقوم الحكومة بواجبها، بل الأسوأ تقول لنا إنّ الإقتصاد لن ينتعش إلّا إذا تعاملتم مع المصارف الحالية، وكأنّ الحكومة تفضّل حماية المنظومة المصرفية الحالية السارقة على حساب الاقتصاد وحقوق الناس، كما ترفض الحكومة ممارسة صلاحياتها بفرض كشف حسابات المصارف وأوراقها، ومقارنتها بأرقام المركزي، بل يتمّ التعامل معها كأنّها «ضحايا»، ويُطلب من الناس أن يثقوا بها مجدّداً، وأن يبتعدوا عن اقتصاد الكاش، في وقاحة غير مسبوقة.
تُترك إدارات المصارف من دون مساءلة أو تدقيق، فيما الجميع يعرف أنّ ثرواتهم تضخّمت، وأنّهم يشترون العقارات في لبنان والخارج، وحتى يشترون مصارف جديدة، في حين أنّ ضحاياهم أُقفلت أعمالهم، خسروا فرصهم، دُمّرت مشاريعهم، واضطرّوا للبدء من الصفر لتأمين الحدّ الأدنى لعائلاتهم.
باختصار، لن يستعيد الإقتصاد اللبناني عافيته، طالما أنّ المصارف نفسها التي ارتكبت سرقة القرن بإشراف المركزي ومسؤولين لا تزال قائمة. فيجب محاسبتها، كما محاسبة المسؤولين في المركزي وكل مَن دعم وغطّى هذه الفضيحة، بالتزامن مع تشجيع فتح مصارف جديدة لينطلق الإقتصاد... إنّ مَن يساهم عن قصد أو غير قصد بمنع فتح مصارف جديدة يرتكب جريمة لا تُغتفر بحق الإقتصاد والناس.
لن نتمكّن من الإقلاع بالإقتصاد وإعادة الحقوق لأصحابها إذا لم نفتح دفاتر المصارف، لنعرف أين ذهبت الأموال بالتفصيل، وإجراء محاسبة فعلية. حينها نستطيع إيجاد حلول فعّالة، لأنّ لبنان غني بمقدّراته.
تزامناً، يجب فتح مصارف جديدة، وضع قوانين تطمئن المستثمر، وإلغاء القوانين الضارة بالاستثمار، والأهم قانون للشفافية المطلقة.
ولكن يبدو أنّ الدولة تنظر إلى المصارف بنوع من الإعجاب الغامض... هل هناك علاقة غرامية سرّية بين بعض السياسيِّين والمصارف والمركزي؟ أم أنّ هناك عنصر جاذبية خفي في هذه المؤسسات لا نستطيع نحن فهمه؟ أو ربما الدولة نفسها وقعت في متلازمة ستوكهولم المصرفي، تعلُّق غريب، مختلط بالإعجاب والاعتياد، يجعلها عاجزة عن الابتعاد عن المصارف القديمة، وكأنّها علاقة غرامية لا تنتهي.
في كل الأحوال، إذا كانت الدولة تصرّ على الإبقاء على هذه المصارف، فلِمَ لا تسمح بفتح مصارف جديدة وتترك الخيار للناس؟ دع المواطن يقرّر بحرّيته، على رغم من أنّنا لا نستطيع تخيُّل مَن سيقف في الطوابير أمام المصارف القديمة بعد ذلك!
فادي عبود - الجمهورية